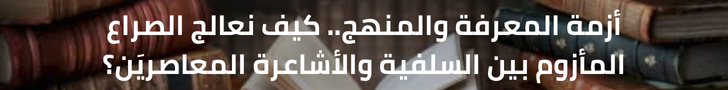الدكتورة فاتن فتحي تكتب: من الرعاية إلى الشراكة.. دعوة لتحويل خبرات 6.2 مليون مسن إلى مخرجات اقتصادية وعملية


في عالم يشهد ارتفاعًا مطردًا في متوسط الأعمار وتزايدًا في أعداد المسنين، تتضح أكثر من أي وقت مضى حقيقة بسيطة وعظيمة: المسن ليس عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا، بل هو ثروة قومية حقيقية تمتلك خبرات ومعارف وأثرًا إنسانيًا وثقافيًا لا يُقدّر بثمن. هذا النمو السكاني يتطلب منا إعادة التفكير في صورة المسن في المجتمع، ليس كفئة مترهّلة في بنية اجتماعية بليدة، بل كمصدر قوة معرفية وروحية وثقافية.
تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد المسنين في مصر ممن يبلغون 60 سنة فأكثر ارتفع إلى حوالي 9.8 مليون شخص بحلول عام 2025، ما يمثل نحو 9.1٪ من إجمالي السكان، وهي نسبة في تزايد مستمر مقارنة بالسنوات السابقة. وعلى الصعيد العالمي، يتوقع خبراء الأمم المتحدة أن يصل عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر إلى 1.6 مليار شخص بحلول عام 2050، أي أن شخصًا واحدًا من كل ستة أشخاص على سطح الأرض سيكون في سن الشيخوخة. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات جامدة، بل تعكس تحوّلًا ديموغرافيًا عميقًا يفرض على المجتمعات إعادة النظر في كيفية التعامل مع كبار السن بوصفهم رصيدًا إنسانيًا ومعرفيًا متراكمًا.
ولا تتوقف قيمة المسن عند حدود الخبرة الحياتية أو الدور العائلي، بل تمتد إلى الإبداع والتأثير العالمي. التاريخ الإنساني زاخر بنماذج لأشخاص بلغت ذروة عطائهم بعد سن التقاعد التقليدي. الكاتبة الأميركية لورا إنجلز وايلدر لم تبدأ أشهر أعمالها الأدبية إلا بعد تجاوزها الرابعة والستين، ومع ذلك أصبحت كتبها جزءًا من الذاكرة الثقافية العالمية. مؤسس سلسلة مطاعم كنتاكي، هارلاند ساندرز، أطلق مشروعه العالمي في الخامسة والستين من عمره، بعد سنوات طويلة من الفشل والتجربة. الفنانة الشعبية “جراندما موزِس” لم تمسك بالفرشاة إلا في أواخر السبعينيات من عمرها، ومع ذلك دخلت أعمالها المتاحف الكبرى. وفي الهند، استطاعت كارتاياني آما أن تحقق أعلى الدرجات في امتحانات محو الأمية وهي في السادسة والتسعين، لتتحول إلى رمز عالمي للتعلم مدى الحياة. هذه النماذج تؤكد أن العمر لا يطفئ جذوة الإبداع، بل قد يمنحها عمقًا ونضجًا لا يتوافر في مراحل العمر الأولى.
في السياق المصري، يحتل المسن مكانة خاصة داخل الأسرة المصرية. الجد والجدة ليسا مجرد أفراد مسنين، بل هما ذاكرة الأسرة الحية ورباط تماسكها وحاضنتها الدافئة، وحلقة الوصل بين الماضي والحاضر. يحملان في الذاكرة قصص الكفاح والعمل، وتحولات المجتمع، وقيم الصبر والانتماء والتكافل. وجودهما داخل الأسرة يسهم في ترسيخ الهوية الثقافية وتعزيز التماسك الاجتماعي، ويمنح الأجيال الأصغر مرجعية إنسانية وأخلاقية يصعب تعويضها بأي وسيلة أخرى.
وقد شهد العالم العربي ومصر تحديدًا نماذج نسائية ورجالية مسنة استطاعت بعد تجاوزها سن 65 عامًا أن تترك أثرًا كبيرًا في مجالات الثقافة والسياسة والمجتمع. من أبرزها الأديبة المصرية أمينة زايد التي واصلت إنتاج أعمالها الأدبية بعد الستين، مقدمًة إسهامات هائلة في إثراء الأدب المصري المعاصر، كما أن الدكتورة فايزة أبو النجا في المجال الطبي استمرت في نشر أبحاث متقدمة أسهمت في تطوير الرعاية الصحية للأطفال وكبار السن. على المستوى العربي، مثلًا الكاتبة الجزائرية Assia Djebar استمرت في الكتابة والمشاركة في النشاطات الثقافية حتى أواخر حياتها، مؤثرة في الأجيال الجديدة من خلال الرواية والمقالة والمسرح، مبرهنة أن التجربة الحياتية الطويلة بعد الخامسة والستين تضيف قيمة معرفية وثقافية لا تُقدر بثمن، وتفتح المجال للقيادات والخبرات الناجحة لاستثمار خبراتها بشكل مباشر في المجتمع.
أما على الصعيد العالمي، هناك العديد من الشخصيات التي شكلت نماذج ملهمة للإنجاز بعد سن 65. على سبيل المثال، نيلسون مانديلا، الذي استمر في العمل السياسي والإصلاح الاجتماعي بعد خروجه من السجن في سن الخامسة والستين، مؤسسًا لمرحلة جديدة في تاريخ جنوب أفريقيا ومُلهمًا للعالم في مجالات السلام والمصالحة. كذلك، ليو تولستوي واصل الكتابة الأدبية والفكرية بعد الستين، مقدمًا أعمالًا أسطورية مثل "الحرب والسلام" و"آنا كارينينا"، التي ما زالت تؤثر في القراء والباحثين عالميًا. حتى في مجال العلوم، نجد ماريا مونتيسوري التي طوّرت فلسفة التعليم الحديثة واستمرت في نشر برامجها التعليمية والتدريبية بعد تجاوزها الستين، محدثة تحولًا كبيرًا في طريقة تعليم الأطفال في أوروبا والعالم. هذه النماذج تثبت أن السن المتقدم ليس عائقًا للإنجاز، بل غالبًا ما يكون مرحلة ذهبية للإنتاج والإبداع والتأثير المجتمعي العميق.
وقد شهد التاريخ الإسلامي العديد من الشخصيات التي قدمت إنجازات كبيرة بعد تجاوزها سن الخامسة والستين، مؤكدة أن العمر لا يقف حاجزًا أمام الإنتاج والتأثير. من أبرزها الخليفة عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية في الأندلس، الذي قاد بناء الدولة وترسيخ مؤسساتها بعد تجاوزه الخمسين واستمر في الحكم حتى سن متقدمة، تاركًا إرثًا حضاريًا وثقافيًا ضخمًا. كذلك، ابن خلدون، مؤرخ وفيلسوف واجتماعي، كتب مؤلفه الضخم "المقدمة" بعد سن الستين، مقدمًا رؤية متكاملة لفلسفة التاريخ والاجتماع لا تزال مرجعًا عالميًا. ومن جهة العلماء، نجد الإمام الغزالي الذي بعد تجاوز الخمسين عاش فترة إنتاج فكري وروحي كثيف، نشر خلالها كتبًا مثل "إحياء علوم الدين"، مؤثرًا في الفكر الإسلامي حتى يومنا هذا. هذه النماذج تثبت أن الخبرة والحكمة المكتسبة مع العمر تمكن الشخص من تقديم أعمال مؤثرة تبقى راسخة في التاريخ والمجتمع.
ورغم هذه القيمة الكبيرة، تشير المؤشرات الاجتماعية إلى تحديات حقيقية تواجه كبار السن، من بينها ارتفاع نسب الأمية بين بعض الفئات، وضعف فرص المشاركة المجتمعية الفعالة، والنظر إليهم أحيانًا باعتبارهم عبئًا على الأسرة أو الدولة. هذا التصور القاصر يتجاهل حقيقة أن الرعاية الاجتماعية للمسنين ليست عبئًا اقتصاديًا، بل استثمارًا طويل الأمد في الذاكرة الوطنية والاستقرار الاجتماعي.
الدستور المصري كفل لكبار السن الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن لهم حياة كريمة. غير أن الرعاية بمعناها الحقيقي لا تقتصر على العلاج والمعاش، بل تمتد إلى إشراك المسنين في الحياة العامة، والاستفادة من خبراتهم في التعليم غير الرسمي، والعمل المجتمعي، ونقل الخبرة للأجيال الجديدة. عندما يُمنح المسن مساحة للتعبير والعطاء، يتحول من متلقٍ للرعاية إلى شريك في التنمية.
في المحصلة.. المجتمع الذي يحترم مسنّيه هو مجتمع يحترم تاريخه ويصون ذاكرته. المسن ليس عبئًا، بل ذاكرة وطن، وضمير تجربة، ومخزون حكمة وخبرات لا يُقدّر بثمن. إعادة تعريف صورة المسن في الوعي الجمعي المصري ليست قضية إنسانية فحسب، بل ضرورة ثقافية وحضارية. فبحفظ كرامة كبار السن، نحفظ تاريخ الأسرة المصرية، ونضمن أن تنتقل القيم والخبرات من جيل إلى جيل، في دورة إنسانية لا تنقطع.